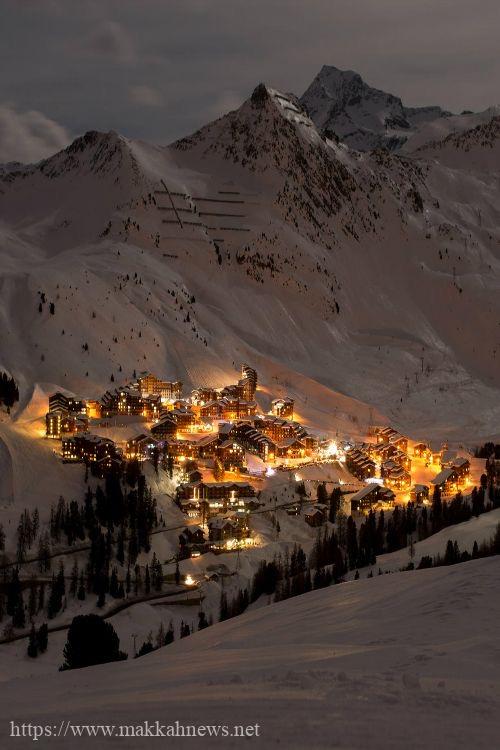العربية لغة الإيجاز
إنَّ أبرز ما يلفتُ الانتباه في لغة العرب أنَّها لغة إيجاز، فكلمة واحدة أو جملة، تحوي ألوانًا من المعاني المتشبعة التي يتلاعب تأثيرها بخيال المتلقي. وعليه، فالإيجاز يعني التركيـز والاقتصار على الجوهـر والتعبير بالكلمة الجامعـة والاكتفاء باللمحـة الدالـة.
فإذا اقتفينا آثار خطى هذه اللغة المجيدة منذ العصر الجاهلي، وجدنا أن العرب حينذاك كانوا شـديدي الحرص على الإيجاز في لغتهم، وقد كانوا يعمدون إلى حذف الحـرف والكلمة والجملة، بل والجمل إذا وجدوا أنَّ المعنى تام بدونها، ويقتصرون على الإشارة المُعبِّرة المُوحِيَة، إعراضًا عن السَّرد المُمِلِّ.
وهكذا كانت السجية العربية الأولى تميل إلى الإيجاز، واللقطات الإيحائية في تعبيرها، حين يغني اللمح عن التفصيل، وهذا ما نلمسه في أمثالهم السائرة، وخطبهم المتقطعة إلى فواصل كثيرة، وفي جعلهم البيت وحدة قائمة بنفسها.
وفي صدر الإسلام كان العرب يجعلون من الإيجاز عمادَ بلاغتهم وركنَ فصاحتهم، وكانت هناك عوامل مُصاحِبَة مع قيام الدولة الإسـلامية دعتْ إلى هذا المطلب البلاغي في لغتهم، إلى جانب أنه طبعٌ وسـليقة في اللغة العربية.
والإيجاز بعد أن كان روحًا وطبيعة لغوية، صار ــ لأهميته في تزيين الأسلوب ــ اجتهادًا ورَوِيَّة وتدريبات.
قالوا عن الإيجاز:
يقول فيه الحكماء: “البلاغة علمٌ كثير في قولٍ يسـير”، و:”خيرُ الكلام ما قلَّ ودلَّ ولم يملّ”، وعمر ــ رضى الله عنه ــ يقـول: “ما رأيتُ بليغًا قطُّ، إلَّا وله في القول إيجاز، وفي المعاني إطالة”. وهذا بعض ما جاء في الإيجاز من أقـوال.
والإيجاز يسمى في بعض الأحيان بالاختصار، وله تعريفات ومفاهيم مختلفة لدى أصحاب البلاغة واللغة. قال السَّكَّاكِيُّ: “الإيجاز أداءُ المقصود بأقلَّ من عبارة المتعارف”. وهو عند الرُّمـانيِّ: “البيانُ عن المعنى بأقلِّ ما يمكن من اللفظ”.
ونجد عند الرماني بالإضافة إلى تعريفه للإيجاز، بيانًا لسبب مدحهم له وتفضيلهم إيَّاه، قال: “والأصـل في مدح الإيجاز والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة في أنفسها، وإنما المقصود هو المعاني والأغـراض التي احتيج إلى العبارة عنها بالكلام؛ فصـارَ اللفظُ بمنزلة الطريق إلى المعاني، وإذا كان طريقان يوصل كل واحد منهما إلى المقصـود على السواء في السهولة، إلّا أنَّ أحدهما أقصرُ وأقربُ من الآخر، فلابد أنْ يكون المحمود منهما هو أخصرهما وأقربهما سلوكًا إلى القصد”.
أنواع الإيجاز:
الإيجاز نوعان:
“إيجاز القصر”. وهو تضمين العبارات القصيرة معانِـيَ كثيرة من غير حذف.. ومن مواضع هذا النوع القرآن، قوله تعالى:
﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾، فهذه الآية مع قِلَّة حروفها، تضمنت معاني كثيرة، فـ”القصاص” لفظ يشمل الضرب والجَرْح والقتل، وبلفظ “القصاص” خرج القتل الخطأ وشِبهه، والدفاع عن النفس الذي لا يُعاقب فاعله بالقتل. كما أن لفظ “حياة” جاء مُنَكَّرًا ليشمل المُتَطَلِّع للاعتداء؛ لأنه إذا علمَ أنَّ العاقبة هي القصاص ارتدع، فيكون سببًا في حياة نفسين. كما أنَّ في القصاص حياة للجماعة؛ لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد، ويظل الثأر مُستمرًا بينهم؛ ولكن إذا اقـــتُصَ من القاتل سلم الباقون.
والنوع الثاني من نوعيْ الإيجاز، “إيجاز الحذف”.
وهو إمَّا أنْ يكونَ بحذف حرف، أو كلمة، أوْ جملة، مع قرينة (علامة) تُعيِّنُ المحذوف.
ومِنْ مواضع الإيجاز بحذف حرف في القرآن الكريم، قوله تعالى ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾، حيث حُذفَ حرف النداء “يا”. ومن مواضع الإيجاز بحذف جملة، قوله تعالى ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أيْ: فتَأَسَّ واصبرْ؛ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ، وهذه الجملة (فقد كُذِبَ رسلٌ..) تعليل للأمر بالصبر.
هذا، وإنْ تباينت النظريات والمفاهيم في تعريف الإيجاز، إلَّا أنَّها كلَّها تتفق على دلالة الإيجاز في الكلام عن طريق الإيحاء، لتناوله للمعاني بصورة أوسـع وأرحب حيث يُطلقُ العنان للذهن يتجول فيها كيف يشـاء دون قيود أو حدود، مادام اللفظ يتملكها بالتفسير أو التأويل.
ولا ينبغي أن يكون مقياس البلاغة في الإيجاز قلة عدد الحروف فقط، بل ما يحمله اللفظ من معنى، وما يثيره من صور وأفكار.
من مواضع الإيجاز بالحذف في القرآن الكريم:
1 ـ الإيجاز بحذف كلمة، ونوعها اسم، وذلك في قوله تعالى:
ﭽ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﭼ
التقدير: هُمْ في سدرٍ مخضود، و”هُمْ” ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجار والمجرور “في سدر” متعلقان بمحذوف خبر لذلك المبتدأ.
2ـ الإيجاز بحذف بجملة، وذلك في قوله تعالى:
ﭽوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ﭼ التقدير: إنْ كنتم كما تقولون، فَلِمَ يُعذِّبكم بذنوبكم؟! وعلى ذلك تكون الفاء داخلة على جواب شرط مُقدَّر، وجملة “لِمَ يُعذبُكم بذنوبكم” هي جواب ذلك الشرط. وجملتا الشرط وجوابه، في محل نصب مفعول به لـ “قُلْ”.
3 ـ الإيجاز بحذف كلمتين، فعل ومفعوله، وذلك في قوله تعالى:
ﭽ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﭼ
التقدير: خلقهنَّ اللهُ. وعلى ذلك يكون لفظ الجلال “الله” فاعلًا للفعل المحذوف، والجملة الفعلية “خلقهن الله” في محل نصب مفعولًا به للفعل ” يقول”، في “لَيقولُنَّ اللهُ”.
4 ـ الإيجاز بحذف كلمة، ونوعها اسم، وذلك في قوله تعالى:
ﭽ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ ﭼ التقدير: ولو شاء الله إعناتَكم، لأعنتكم، بنصب “إعناتكم” على أنَّه مفعول به؛ وذلك أنَّ “شاء” فعلٌ متعدٍّ.
5 ـ الإيجاز بحذف كلمتين، فعل ومفعوله، وذلك في قوله تعالى:
ﭽ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً (50) أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﭼ
التقدير: قل يُعيدكم الذي فطركم؛ فالاسم الموصول “الذي” فاعل للفعل المحذوف “يُعيد”، والجملة الفعلية “يُعيدكم الذي فطركم” في محل نصب مفعول به للفعل”قُلْ”.
ونختم هذا الحديث الموجز بالقول: بما أنَّ الإيجاز من أهمِّ السِّمات التي تتميَّز به هذه اللغة وأهلها؛ إذْ هو مظهر من مظاهر البلاغةٌ وامتلاك الأديب لناصية البيان، والقدرة على إحداث التأثير ـ فإنَّه يُعدُّ ضرورة تقتضيها طبيعة عصرنا الذي يتَّسم بالسرعة في كلِّ الأمور؛ فلابُدَّ أنْ يجعله الكُتّاب سمة لكتاباتهم، وذلك يتطلب دُربة ومِرانًا واستحضارًا.
******
http://arbtech.ahlamontada.com/t381-topic بتصرف وحذفٍ كثير وإضافة.
https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/secrets/2014-07-12-1.2162417