تُعد الحوافز من المواضيع التي أثارت اهتمام القادة والباحثين على مرِّ العصور الماضية حتى وقتنا الحالي، فقد أجرى (السلمي) دراسة عام (2015)؛ لمعرفة علاقة الحوافز المادية والمعنوية في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي إدارة الموارد البشرية في مدينة الأمير سلطان الطبية في الرياض، والبالغ عددهم (152) موظفًا؛ خلصت الدراسة إلى وجود مستوى أداء مرتفع جدًا بمتوسط حسابي بلغ( 4.48 من5) إذ بلغ المتوسط الحسابي(3.86 من 5) للحوافز المالية و(4.03) للحوافز المعنوية كما أوردهما (الهندي والمطلق) في النموذج المقترح لنظام الحوافز، وعلى هذا؛ فالحافز هو كل ما يدفع الفرد إلى العمل. ومن النادر أن نجد أبحاثًا أو دراسات حول الإدارة لم تتطرق إلى موضوع الحوافز وأهميتها في توجيه العاملين في المنظمات، ولأننا نعيش في عصر أصبح فيه العنصر البشري يتسم بمستوى عالٍ من العلم والثقافة، ونتج عن ذلك تعدد احتياجاته وتنوع طرق تحفيزه. وقد تطرقت العديد من الكتب في مجال الإدارة إلى الأنواع المختلفة من الحوافز منها: الحوافز الداخلية، والحوافز الخارجية، وكُل منهما تتسم بصفات تجعلنا نتساءل عن الأقوى في تحفيز العاملين نحو العمل والاستمرارية في المحافظة على جودة العمل.
تُعرف الحوافز الخارجية كما عرفها (الطجم وطلق بن عوض) في كتابهما (السلوك التنظيمي 2003م) بأنها المؤثرات الخارجية التي تُحفز الفرد وتشجعه للقيام بأداء أفضل. ولكن الكثير من الكتب والأبحاث أشارت إلى أن هذا النوع من الحوافز الخارجية أقل فاعلية وقوة مقارنة بالحوافز الداخلية؛ وذلك لأن متى ما توقف هذا النوع من الحوافز قد يتوقف معها الأداء الجيد من العامل كالطفل الذي يتصرف بالسلوك الذي ترغب فيه عندما تقدم له الحلوى -على سبيل المثال- ولكن مجرد عدم تقديمك أي شيء له فقد يرفض القيام بالسلوك المرغوب؛ لأن الحافز الخارجي يعتمد على ما يتلقاه الفرد من البيئة المحيطة به.
أما عن الحوافز الداخلية والتي يُطلق عليها أيضًا بمصطلح الدافع؛ فكما ذكر في كتاب (السلوك التنظيمي) لـ (الطجم وطلق بن عوض) بأنها عبارة عن شعور وإحساس داخلي يوجه سلوك الفرد نحو سد حاجة معينة والقيام بالعمل. ولطالما كانت الحوافز الداخلية هي الأقوى تأثيرًا على الفرد العامل؛ لأن مصدرها الرغبة والشغف اللتان يمتلكهما العامل اتجاه المهنة التي يعمل بها، فقد أشار (إتش. بينك) في كتابه (الحافز) عن إحدى نظريات العالم (دوجلاس ماكر يجور)، والتي تدعى بنظرية (X) ونظرية Y)) لتفسير سلوك الإنسان، فالنمط السلوكي Y)) يعتمد بشكل كبير على الرغبات الداخلية أكثر من الرغبات الخارجية؛ لأنه يهتم بشكل أقل بالمكافآت الخارجية التي يقود إليها أي نشاط وبشكل أكبر بالرضا الناتج عن النشاط نفسه، مما يجعل الفرد أكثر دافعية للعمل؛ وذلك لاعتماد السلوك (Y) على ما يمتلك الفرد من حافز داخلي.
ومن ثم يتضح أنَّ للحوافز الداخلية قوة وتأثيرًا على سلوك الفرد، كما أنها لا تتوقف على مكافأة نقدية يتحصل عليها الفرد كي يقوم بالعمل المطلوب منه؛ لأن المكافآت النقدية أو أي نوع آخر من الحوافز الخارجية تعود على أساليب التحفيز قصيرة المدى -أي أن تأثيرها يكون لفترة زمنية قصيرة ومن ثم يحتاج للمزيد من المكافآت المالية بعد انقضاء هذه الفترة للإنتاجية-. وقد ذكر (الشميمري وآخرون) في كتاب (مبادئ إدارة الأعمال) مناهج الإدارة والتي منها المدرسة الكلاسيكية/ التقليدية والتي تتمحور حول مفهوم ضرورة معاملة الإنسان كالآلة حيث يُحفَّز بواسطة المكاسب المادية فقط، مما ترتب على مفهوم الإدارة العلمية تحقيق التقدم الصناعي في كل من أمريكا وفرنسا، إلا أن هذا المنهج قد وجد مقاومة شديدة في المجتمع الأمريكي، وكان من أبرز الانتقادات الموجهة إلى المدرسة الكلاسيكية تجاهلها للنواحي الاجتماعية والسيكولوجية للإنسان؛ لذا برزت بعد ذلك أهمية الحوافز المعنوية والداخلية، ودورها في زيادة الإنتاجية على المدى البعيد.
أثبتت الدراسات التي أجراها كل من (ليبر) و(جرين) مع زميلهم الثالث (روبرت نيسبت) والتي ذُكِرت في كتاب (الحافز) لـ (إتش بينك)، مُبيّنة فعالية وقوة الحافز الداخلي على الأفراد. فقد راقب الباحثون الثلاثة فصلًا دراسيًا لأطفال بإحدى المدارس اختاروا قضاء وقت لعبهم المفتوح في الرسم، فقام الباحثون بتقسيم الفصل إلى ثلاث مجموعات:
1- المجموعة الأولى: سميت بمجموعة (المكافأة) فقد أظهروا فيها لكل طفل شهادة (أحسن لاعب)، وقد جرى سؤال أطفال هذه المجموعة عما إذا كانوا يرغبون بالرسم مقابل الحصول على هذه الجائزة (أي أنَّ كل طفل يرغب بالرسم سيحصل على هذه الجائزة في البداية قبل البدء في الرسم).
2- المجموعة الثانية: هي مجموعة (المكافأة غير المتوقعة) أي أنه إذا قام الأطفال بالرسم يمنح كل طفل شهادة تقدير في النهاية (عند الانتهاء من الرسم).
3- المجموعة الثالثة: وهي مجموعة (اللامكافأة) فإذا قام الأطفال بالرسم لن يحصلوا على أيِّ شهادة لا في البداية ولا في النهاية.
بعد مرور أسبوعين بدأ الباحثون بتنفيذ التجربة ومراقبة الطلاب، فلاحظ الباحثون أن طلاب مجموعتي (المكافأة غير المتوقعة) و(اللامكافأة) قدموا رسومات بنفس الاستمتاع الذي كانوا يشعرون به قبل التجربة، أما طلاب المجموعة الأولى (المكافأة) فقد توقعوا المكافأة وحصلوا عليها في البداية بالتالي أظهروا اهتمامًا أقل بالرسم؛ لأن متعة اللعب تحولت إلى عمل؛ وذلك نتيجة لربط الرسم بالحصول على المكافأة.
فمن خلال التجربة السابقة التي قام بها الباحثون اتضح لنا أن هذه المكافآت المشروطة قد أماتت المحفز الداخلي عند أطفال (المجموعة الأولى) فقد حصلوا في البداية على المحفز الخارجي مما جعلهم يظهرون اهتمامًا أقل بالرسم؛ فكان الأداء أقل كفاءة مقارنة بالمجموعات الأخرى، وليس هناك أي استمتاع بما يقومون به؛ فإن فقدنا الاستمتاع في الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها ستكون النتيجة غير مرضية؛ كون المتعة في العمل -أيًّا كان نوعه- تجعلنا دائمًا نبدع وننتج إنتاجًا أفضل، لذلك كلما حرصت على الاختيار الجيد للكوادر البشرية العاملة التي تمتلك الشغف اتجاه هذه المهنة، ومشاركتهم في الرأي نحو ما يخص العمل، كانت الإنتاجية أفضل والأداء كما ينبغي، وكل ذلك من الأساليب الناجحة في بناء الحوافز الداخلية والمعنوية عند الأفراد.
والخلاصة أن الحوافز الداخلية هي التي تمتلك الدور الكبير والأساسي في المحافظة على جودة العمل والإنتاجية عند الأفراد أيًّا كان ما يقومون به من أعمال، سواء أكانت أعمالًا مكتبية في وظائف مهنية أم دراسية لطلبة العلم. ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقدم الحوافز الخارجية من مكافآت نقدية وغيرها بالشكل الذي يدعم الحافز الداخلي ولا يميته، كأن تكون مكافآت بأسلوب غير شرطي، فمن رأيي كلما كان الأفراد العاملون شغوفين بمهنهم وأعمالهم التي يقومون بها، وراغبين حقًا في العطاء والإنتاجية، ودعمنا حوافزهم الداخلية أكثر من أي شيءٍ آخر، زاد استمرار عطائهم المتميز على المدى البعيد، وتحسنت إنتاجيتهم، وبالتالي إنتاجية المنظمات.

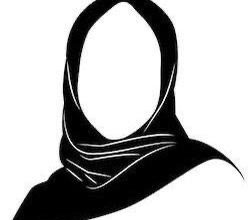

مقال يستحق التوقف عنده طويلا لجماله وفائدته وعمقه
بوركتِ اختي أ. وفاء
كل الشكر والتقدير لكِ أستاذه ليلى
مقدّره وشاكره لكلماتك ووقفتك