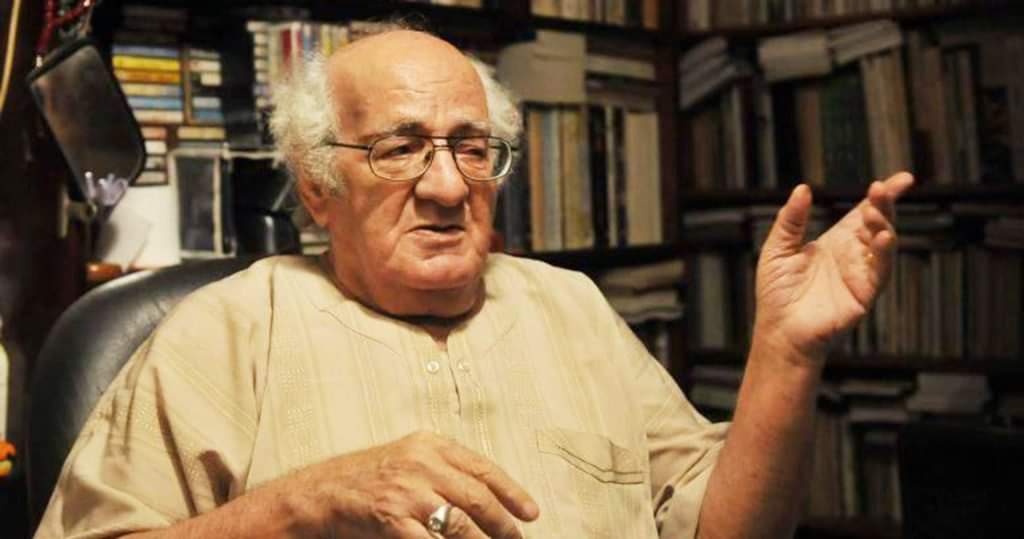
“تنوع التجارب… تأمل المصائر”
بقلم: د. حسين حمودة
(قراءة فى مجموعة خيرى شلبى “ما ليس يضمنه أحد”!)
ـ 1 ـ
تضم مجموعة خيرى شلبى (ما ليس يضمنه أحد!) تسع عشرة قصة متنوعة العوالم؛ تنهض على تناولات لتجارب مترامية الأبعاد، متعددة المسارات ، تتأمل ـ فيما تتأمل ـ آثار الزمن الذى انتأى عن ماض أول انقطعت السبل إليه، وتستكشف ـ فيما تستكشف ـ العلاقات الإنسانية بما تنطوى عليه من تواصل الشخصيات وانفصالها، اندماجها العابر وتوحدها المقيم، وتحتفى ـ فيما تحتفى ـ بتجسيد المفارقات التى أحاطت بمصائر كبرى ترتبت على سلوك واحد صغير، ربما لم يكن أكثر من هفوة عابرة. كذلك تتحرك هذه القصص التسع عشرة بين فضاءات المدينة والريف، وتتنقل بين ملامح التاريخ المحدد المتعين وأجواء “الأمثولة”، أبدية الزمن، التى تجاوز كل تاريخ.. وتنهض القصص، خلال ذلك كله، على صيغة من صيغ “الحكى الحميم”، باتت معلما من معالم كتابة خيرى شلبى القصصية والروائية؛ حيث الاحتفاء بـ”الحكاية” التى لها قوام واضح، فيها يتشكل خطاب الحكى خلال اتصال حميم حى، يكاد يكون مسموع الصوت، بين راو يحكى إلى “محكى له” ـ “مروى” عليه فى تصورات أخرى ـ وحيث الاهتمام بالمغزى، الأخلاقى أحيانا، الذى يتخلق فيما بعد وصول “القصة/الحكاية” إلى نقطتها أو ذروتها الأخيرة، وحيث اللغة القصصية التى تحفل بتراكيب وتعبيرات حية، وحيث القص فعل قائم على البساطة والتشويق والإمتاع ، حتى وإن نحا، فنيا، منحى التجريب والاستكشاف والمغامرة. وعلى ما يجمع القصص من هذه القسمات والمعالم، وغيرهما من قسمات ومعالم أخرى، فثمة دوائر تنتظم عددا من هذه القصص، ومسارات يمضى فيها بعضها، وإن تماست هذه الدوائر فى غير حالة، وتداخلت تلك المسارات فى أكثر من وجهة.
ـ 2 ـ
فى قصص مثل (نزف كبرياء مهيض)، و(مقام الضوء)، و(مشوار مبهم) ـ وهى متتالية الترتيب بالمجموعة ـ تجسيدات متنوعة لمعنى التوحد؛ تناولات متباينة الزوايا للذات التى تجتر الوحدة وتكابدها، سواء أكانت تقبع بمفردها، معزولة عن الآخرين، أم كانت تتحرك معهم وبينهم. فى القصة الأولى نسمع صوت زوجة “الأستاذ”، الذى صعد سلم المجد، وتركها ـ أو تخلى عنها ـ فى مواجهة وحدتها، إذ تعيش بمفردها فى فيلا من دورين، بعدما تفرق أبناؤهما فى جنبات الأرض، وهى تبوح بما يشبه النزيف ـ لاحظ عنوان القصة ـ “ياناس هو [زوجها] لم يعد هنا! انفصلنا! لست أعرف عنوانه! لا أعلم عنه شيئا (…) سنوات طويلة مضت حتى نسيت أنا نفسى أننى كنت ذات يوم زوجة للباشمهندس (…) وأننى أنجبت منه أربعة أولاد بأربع أسر كبيرة فى هولندا وكندا ونيويورك حتى شبحه لم يعد يظهر..إلخ” (القصة، ص 19). وفى القصة الثانية نحن مع الزوجة التى غيب الموت زوجها الفنان، ولم يعد لها من عزاء سوى زيارة قبره مرة كل أسبوع، فى سفرة متكررة، عبر سنوات سبع، تقطع خلالها المسافة من الجيزة إلى بورسعيد، وهناك تشعر هى وطفلتها بلهفة واغتباط واشتياق “العائد إلى بيته الحقيقى (…) لم يعد القبر قبرا بل أصبح مقاما” (القصة، ص 27)، ولكنها، هناك أيضا، لا تستطيع سوى أن تلحظ المشهد الذى يجابه عينيها: “المقبرة والحجرة وأفرع الصبار وشجيرات الورد” و”على مدد الشوف مدينة بورسعيد كابية الضوء باركة على نفسها كبقايا مراكب عتيقة لفظها البحر من أزمنة بعيدة، وليس ثمة من قبل حى [كذا] هاهنا سوى هذا الذى يطل فى استقبالهما من تحت هذا المقام” (القصة، ص 28). وفى القصة الثالثة نشهد “سمير بك”، الذى أحيل إلى “المعاش” منذ سنتين، و”تزوج أولاده ورحلوا إلى بلاد بعيدة وراء أرزاقهم” و”ماتت زوجه بعد صراع طويل مع المرض” “يشعر بوحدة موجعة” (انظر القصة، ص 30)، يتطلع إلى الصور المعلقة حواليه على الحوائط، ويسعى إلى أن يقتنص من ملامح شخوصها ما يساعده على مدافعة إحساسه بالوحدة: “زوجه وعياله وأقاربه وأزواج وزوجات عياله يرمقونه من براويز الصور” (القصة، ص 32)، لكنه سرعان ما يؤوب إلى معاناته المقيمة، “يفكر فى وحدته الموحشة”، ويتكشف له “أنه لم يكن طوال عمره إلا وحيدا” (القصة، ص 33). ويتصل بهذه القصص، وكلها مرتبط بعالم المدينة، قصة “الخروج من المحارة”، التى يتحول فيها الريف، أو “البلد”، إلى محض ذكرى مراودة ومقلقة للأستاذ الأكاديمى البارز، الذى بات يتوجس من رنين الهاتف، متوقعا سماع “خبر فاجع” عن أمه المريضة فى “البلد”، الراقدة “تحت عمر يجاوز الثمانين عاما..إلخ” (القصة، ص 112)، غير قادر على أن يكون بجانبها، وغير قادر على أن يخدش صلابة المحارة المحيطة به هنا، وهى نفسها المحارة التى يغلقها الإنسان حول ذاته ـ أو تنغلق هى بفعل ملابسات معقدة ـ فى عالم المدينة، ولا يستطيع الخروج منها أبدا، وإن تعددت محاولاته.
ـ 3 ـ
فى مقابل قصص “التوحد” ـ التى يتأسس أغلبها على تجارب تتصل بعالم المدينة ـ ثمة قصص يتخللها صوت جمعى ما، وتقترن بتناولات الريف أو البلدة (باستثناء قصتين لاح فيهما هذا الصوت، تنتمى وقائعهما إلى القطاع التحتى من المدينة)؛ إذ تدور هذه القصص فى مجال الريف أو “البلدة”، وتكشف عن عوالمهما، أحيانا بنزوع “أنثروبولوجى” يرصد طقوس الحياة وأساطيرها وأدبياتها الراسخة، الثابتة، وأحيانا بالتقاط وقائع استثنائية تختبر هذا الرسوخ وذاك الثبات؛ تتوتر مع ذلك كله أو تضعه موضع التساؤل. وفى هذه القصص تختفى مظاهر الوحدة ومكابداتها، ويتم التوقف عند وقائع تبدو خلالها علاقات الشخصيات مترابطة متماسكة، ولكن أيضا تتجسد فيها نوازع هذه الشخصيات ورغائبها الكامنة الدفينة، وشرورها ومؤامراتها الصغيرة، التى تصاغ هنا صياغة تحنو على “الضعف البشرى”، بما يجعلنا “نتفهم” النزوع إلى الشر والتآمر، بل ونلتمس له المسوغات والمبررات.
فى هذا المنحى ثمة قصص: (فتح المندل)، (الغضب)، (العفاريت التى تسكننا)، (الاشتياق لليلة حالكة). فى تلك القصص يختفى التركيز على شخصية واحدة، ويتحقق الحدث القصصى عبر مشاركة كثرة من شخوص تربطها علاقات متواشجة، بل تقوم أحيانا بفعل واحد، كما يتم التركيز على هذه الشخوص بشكل متساو، متكافئ، تقريبا. كذلك يتحدث الراوى فى هذه القصص بصوت هذه الشخوص جميعا، أو ـ فى بعض المواضع ـ يتحدث بصوت جماعات محددة منها؛ ومن هنا يكاد شكل الراوى المفرد المحدد يتلاشى فى هذه القصص لتحل صيغة أخرى لراو يتحدث بضمير جمعى، ولكن بطرائق متباينة أو على مستويات متنوعة. ففى بعض سياقات قد يشير الضمير الجمعى ـ بمعنى من معانى الانتماء ـ إلى “البلدة” كلها: “فى بلدتنا إلى زمن قريب جدا كان الواحد..إلخ”، “كعادة أهل بلدتنا..إلخ” (قصة “فتح المندل”، ص 52، و ص 53 على التوالى ـ وهذا التشديد وكل التشديدات التالية فى نصوص القصص من عندنا)، “عم عبده السيد عبده أحد المعالم الأثرية البارزة فى بلدتنا” (قصة “الغضب”، ص 90)، “يدير مكنة الطحين الوحيدة فى بلدتنا” (قصة “العفاريت التى تسكننا”، ص 104). وفى سياقات أخرى قد يتم تخصيص هذا الضمير الجمعى ليومئ إلى دائرة أصغر، تنحصر فى “الدار” أو فى “المندرة” التى ينتمى الراوى إلى أهلها: “نحن عيال الدار” (قصة “فتح المندل”، ص 54)، “فى مندرتنا حيث أبى وأعمامى وصحبهم..إلخ” (قصة “العفاريت التى تسكننا”، ص 107 ـ والضمير الجمعى فى هذا العنوان يشير إلى جماعة أكبر، لعلها تشملنا نحن القراء). كما قد يتم الجمع فى سياق ثالث، داخل الفقرة الواحدة، بين الدائرتين؛ البلدة والدار أو المندرة (انظر قصة “الاشتياق لليلة حالكة”، الفقرة الثانية، ص 138). واللافت فى هذه الوجهة تحول البلدة كلها أو “المندرة” إلى ما يشبه شخصية إنسانية واحدة، حية عاقلة: “البلدة كلها تعرف أنه ليس يفشر..” (ص 90)، “فمندرتنا أم العقلاء لا تحسم شيئا ولا تقول رأيا محددا فى شيء” (ص 107). أما فى القصتين اللتين لاح فيهما هذا الضمير الجمعى، واتخذتا من قاع عالم المدينة مجالا لهما، فقد أطل هذا الضمير فى موضعين عابرين فقط، مرتبطا مرة بـ”الغرزة” ومقترنا مرة ثانية بحارة شعبية فقيرة هى “حارة الوطاويط”: “عصر كل يوم فى غرزتنا المفضلة فوق علواية زقاق المدق المتفرع من شارع الصنادقية..إلخ” (قصة “نفايات ذاتية”، ص 10)، “[فى] حارة الوطاويط فى منشية ناصر، نسمع صوتها [الجارة أم هبة] وهى تسب العيشة واللى عايشنها” (قصة “أكل العيال”، ص 142).
ـ 4 ـ
أيا كانت القسمات التى تسم العلاقات الشخصيات فى قصص (ماليس يضمنه أحد!)، متوحدة منفصلة أو تتحرك بوصفها جزءا من كل، فإن تأمل مسار حيوات هذه الشخصيات يمثل سمة أساسية فى التوجه الذى تنطلق منه قصص المجموعة جميعا.
تقصى الصلة بين البدايات والمآل؛ الاختيارات الأولى والمصائر النهائية؛ الأوضاع التى لا تخلو من مفارقة بين ما أصبحت تعيشه الشخصية الآن، فى الحاضر القصصى، وما كانت تصبو إليه فى زمن قديم؛ الأواصر بين تجربة الحب الأول والحياة العاطفية ـ أو التى نضب نبعها من كل عاطفة ـ الممتدة عبر مسيرة كاملة للشخصية (انظر قصتى “مشوار مهم”، و”الخروج من المحارة”)؛ معنى الأسرة ومعنى القرابة، أو الصلات التى تعقدها المعايشة و”العشرة” فى مواجهة الرابطة التى تتأسس على وشائج الدم (انظر قصة “جملة موسيقية)؛ السلوك الجزئى اللحظى العابر الذى يمكن أن يمتد، مراودا وملحا وثابتا، غير قابل للنسيان، عبر زمن طويل متصل، لا يمكن أبدا تداركه أو علاجه (انظر قصة “العلاج المستحيل”) بل قد يمتد طيلة عمر بأكمله أو أعمار بأكملها (انظر قصة “البلد البعيد”)؛ مقاسمة آلام الآخرين الواضحة المعلنة فيما تكون الذات مترعة بآلام شتى مستترة، ماثلة فى الحاضر القائم أو قادمة فى زمن محتمل (انظر قصة “نفايات ذاتية”) .. إلخ، هذه كلها أعمدة أساسية فى تجارب الشخصيات التى تتوقف القصص لتجسدها، أو لتومئ إليها، أو لتنتهى إليها وبها فى نهايات لا تخلو من مغزى أخلاقى واضح. وقريبا من هذا المنحى، يتوقف بعض القصص عند ظواهر بعينها تصاغ بملابسات أكثر تحددا: العلاقة بين الجوهر الكامن والمظهر المرئى الخارجى، متمثلة فى الصورة التى تضفيها الملابس على من يرتديها (انظر قصتى “الثياب العارية” و”بكوية من سوق الكانتو”)؛ القيمة التى تنجزها الشخصية بعيدا عن حظوظ ممنوحة معطاة جاهزة سلفا، تتأتى من ولادة هذه الشخصية فى وضع اجتماعى “مريح” لم تسهم فيه، أو ـ بمعنى أبسط ـ ما تحققه الشخصية بكدها أوبسعيها الخاص وما تناله بجهود أهلها (انظر قصة “حدوتة قديمة”)؛ المراوحات ـ فى حياة الممثل ـ بين الدور والشخصية، اللحظة والأبد، “التشخيص” والمشاعر الحقيقية، وأخيرا النجاح والإخفاق (انظر قصة “فيدرا الآثمة”).
هذه التأملات، وغيرها، تكشف عن حكمة يتم استخلاصها وبلورتها من تحليل الملابسات التى ترسم المصائر الإنسانية، وهى حكمة تتأسس على إيمان، كامن فيما وراء الكتابة وفيما قبلها، بدور ما يمكن أن يضطلع به الأدب. ومثول هذه التأملات لا ينأى بعالم/ بعوالم القصص بعيدا عن شروط الكتابة الأدبية، فلا يتحول “حكى” هذه القصص ـ مثلا ـ إلى أفكار أو تصورات مجردة؛ فكل هذه التأملات ليس لها حضور مباشر داخل النصوص، وإنما هى أقرب إلى أن تكون معانى وأفكارا وتصورات تتخلق داخل القارئ فيما بعد قراءة النص كله، أو فيما بعد الانتهاء من الجملة الأخيرة فى كل قصة من القصص. إن هذه التأملات ـ بهذا المعنى ـ أشبه بامتدادات تسرى داخل متلقى القصص أو قارئها، خارج أو عقب ما يقرأ من قصص تنم طريقة كتابتها عن ثقة به، وبقدرته على الوصول إلى أغوار المعنى أوالمغزى، حتى وإن أعانته هذه الطريقة، من ناحية أخرى، خلال تكوينات فنية تنهض على “احتفاء توصيلى” واضح، بتقديمها مفاتيح سهلة تقود إلى بوابات عوالم النصوص القصصية وتفضى إلى دروبها وطرقها الممهدة بعناية.
ـ 5 ـ
يتجسد ذلك الاحتفاء “التوصيلى” فى قصص المجموعة بملامح عدة، منها ما يبدأ من عناوين القصص نفسها، ومنها ما يرتبط ببنائها، ومنها ما يتعلق بنهاياتها.
صياغة عناوين القصص تنطوى على ما يشبه النزوع التعليقى؛ وكأن كل عنوان يرنو إلى عالم القصة كله من موقع آخر، أو يطل عليه من منظور مغاير، هما ـ هذا الموقع وذاك المنظور ـ موصولان بما وراء الإلمام بأحداث القصة جميعا. فعناوين: “نفايات ذاتية”، و”نزف كبرياء مهيض”، و”الخروج من المحارة”، و”الثياب العارية”، و”البلد البعيد”، مثلا، يعبر كل واحد منها عن نظرة من عل، ومن نقطة نائية، لكل ما يتوالى فى عوالم هذه القصص من وقائع، بما يجعل هذه العناوين، على مستوى من المستويات، اختزالا لوقائع القصة وإجمالا لها بل وتأويلا أساسيا من تأويلاتها.
وبناء أغلب قصص المجموعة يتأسس على التقاطات لمفارقات متعددة الأبعاد، أغلبها يتركز فى نهاية القصة ليبرز مغزاها ويؤكده، فيما يمثل “مركز ثقل” فنى متأخر أو مرجأ، خلاله يتكشف للقارئ، فى لحظات متلاحقة مكثفة، مغزى الوقائع التى تتابعت وتراكمت وأسلم بعضها إلى بعض. نلحظ المفارقات الأخيرة هذه فى أغلب قصص المجموعة، وإن اتسمت فى بعض القصص بطابع مأساوى أو شبه مأساوى، كما هو الحال فى نهايات قصص مثل: “نزف كبرياء مهيض”، “مقام الضوء”، “فيدرا الآثمة”، “شفاء الغل” (وهذه القصة الأخيرة، بالمناسبة، تقوم على محاورة مع “تيمة” Theme من تيمات رواية نجيب محفوظ “اللص والكلاب”: الخارج من السجن ساعيا إلى الانتقام ـ أو إلى تحقيق عدالة غائبة ـ ممن خانوه، ولكنه لا ينجح فى قتلهم بل يقتل آخرين أبرياء، تمثلهم هنا ابنته نفسها!)، وأيضا كما هو الحال ـ بوضوح أقل ـ فى قصص مثل: “بكوية من سوق الكانتو” (من يحكم عليه بعشر سنوات فى السجن، لمجرد أنه اشترى ثيابا مستعملة لم يكن يعرف أنها كانت تخص محتالا مقامرا)، و”العلاج المستحيل” (التماس الغفران، دون جدوى، من قط لم يغفر أبدا، طيلة سنوات عشر، سلوكا عدوانيا لمن أحبه من قبل حبا جما)، و”البلد البعيد” (الانتهاء إلى ذهول مطبق، حيث الممثل اللامع يتحول إلى مشرد غائب العقل، هائم فى الشوارع، لا يعرف “صديق عمره” ـ الذى يلتقيه ويتعرف عليه بصعوبة ـ ويسأله برجاء: “من فضلك البلد دى اسمها إيه؟”). وتبلغ المفارقات المأساوية الختامية ذروتها فى القصة الأخيرة بالمجموعة، “أكل العيال”، حيث الأم التى تصدمها مركبة تشبه الدبابة وتسحق ذراعها اليسرى، فتنهض لتجمع بذراعها “الحية” الأرغفة التى كانت قد اشترتها، صارخة:”أكل العيال ياخرابى يا مصيبتى أكل العيال راح!”، قبل أن “تسقط على الأرض فى غيبوبة، وذراعها الباقية تحضن ما جمعته من أرغفة”.
ـ 6 ـ
ضمن هذه التأملات، بمفارقاتها، ما يتصل بتجسيد هاجس مرور الزمن، متمثلا فى تباعد المسافة بين البدايات والنهايات، الأحلام الأولى والنهايات الأخيرة، وفى الانتقال من الطفولة إلى الشيخوخة، وفى تحول المشاعر المتأججة إذ تؤول إلى انطفاء وخمود، وأحيانا ـ على العكس من هذه الدلالات ـ يتمثل مرور الزمن فى التوصل إلى خبرة جديدة، أو فى اكتشاف متأخر، لكنه جذرى، يشبه الانتقال من العمى إلى البصيرة.
فى هذا المنحى، ثمة كثرة من العبارات التى تصور هذه المعانى، تتناثر على صفحات قصص المجموعة كلها تقريبا: “زوجى التى ظلت طوال عمرى أحلف بحياتها أصبحت تكاد تكون نسخة طبق الأصل من عايدة” (ص 13)، “لم يعد [الزوجة تتكلم عن زوجها] البيت بيته من خمستاشر سنة!” (ص 17)، “برفقتها صبية (…) كانوا يرونها منذ سبع سنوات طفلة تنام على حجرها..” (ص 22)، “[أحيل] إلى المعاش منذ سنتين (…) ماتت زوجته بعد صراع طويل مع المرض اللعين..” (ص30)، “قنينة شامبو راقدة تحت رف الصابونة والليفة، قد مضى عليها فى رقدتها ما يزيد على خمس سنوات” (ص 31)، “ياالله. ما يقرب من خمسين عاما مرت..” ص 35)، “فيوم تركتها وهى فى الثالثة من عمرها كانت سنك وقتها عشرين عاما (…) أما الآن فقد تجاوزت الأربعين” (ص 60)، “المدهش أننى وزوجى بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات من طردنا لنور، بدأ الحنين إليه يغزونا..” (ص 102)، “هذه النافورة العاطفية السخنة التى كانت اضمحلت من حياته طوال ما يقرب من نصف قرن..” (ص 113)، “..اختفت من حياته تماما، وطوال الأربعين عاما الماضية كانت تبلغه بعض أخبارها..” (ص 114)، “لم يعد يشغلها شييء فى الدنيا سوى مطلب واحد أن تراه فورا وبفارغ الصبر ليطفئ اشتياقا تشتعل ناره طوال أربعين عاما..” (ص 115)، “بعد أربعين عاما كنت قد أحلت إلى المعاش من وظيفتى فى إدارة المسرح، وبلغت الخامسة والسبعين من العمر..” (132)، “الذى فعل بها ذلك لم يكن أنا، إنما هو شخص آخر احتل عواطفى ثلاثين عاما فنقل إلى مأساته لقد مغفلا حقا” (ص 14).
مرور الزمن، فى أغلب السياقات الأكبر لتلك العبارات، يتم اختزاله أحيانا خلال إطلالات سريعة ـ تشبه ومضات خاطفة ـ على لحظات حاضرة تطل على ماض بعيد. وأحيانا ينعكس مرور الزمن، بمنحى أكثر تفصيلا، على مرايا زيارات أكثر تريثا لساحات ذلك الماضى. من هذه الإطلالات والزيارات تلك التى ترتبط بتجارب حب أول مستعاد، مبتعَث، قد انتهى فى الزمن الحاضر إلى نوع من موات أو آل إلى موت فعلى (انظر قصتى “الخروج من المحارة” و”مشوار مبهم”)، ومن هذه الإطلالات والزيارات ما يمثل محض ذكرى، وإن كانت أحيانا حية متدفقة، أو يفسر بعدا أو موقفا فى الحاضر، دفع إليه حادث قديم ينتمى إلى زمن غابر، بما يجعل للماضى أثرا ثابتا، ماثلا فى كل زمن (انظر قصتى “بكوية من سوق الكانتو” و”العلاج المستحيل” و”الاشتياق لليلة حالكة”)، ومن هذه الإطلالات والزيارات ما يتعلق بإعادة اكتشاف ـ فى زمن متأخر جدا ـ علاقة الإنسان بذاته وبالآخرين المقربين منه (انظر قصة “نفايات ذاتية”).
ـ 7 ـ
طرائق “حكى” هذه القصص تعكس تعددها وتنوعها اللافتين. وإذا كانت صيغ الراوى ـ فيما لاحظنا ـ تتحرك بين الصوتين الفردى والجماعى، فى دائرتين من الدوائر التى تنتظم قصص المجموعة، فإن نبرات صوت هذا الراوى تتراوح أيضا من قصة لأخرى، و”شخصيته” تتباين كذلك (من شخصية الطفل، “العيل” ضمن عيال كثيرين، مثلما هو الحال فى قصة مثل “فتح المندل”، إلى شخصية “الكبير المدرك”، مثلما هو الحال فى قصة مثل “العفاريت التى تسكننا”)، كما أن موقعه يختلف من قصص يرصد فيها العالم بنظرة العارف الرائى العليم (مثلما هو الحال فى قصة مثل”مقام الضوء”)، إلى قصص أخرى يوازى فيها شخصية واحدة، ويكاد يكون تعبيرا عن صوتها الداخلى أو “مونولوجها” الخاص (مثلما هو الحال فى قصتى “مشوار مبهم”، و”أكل العيال”)، بل وتتداخل فى غير موضع لغة الراوى مع لغة الشخصية (“إذا إن حيواناته المنوية بعيد عنك ميتة، لكنه استعاض عن الخلفة بإخوته السبعة..إلخ” ـ قصة “شفاء الغل”، ص 64)، بالإضافة إلى أن صور الراوى تتغاير من قصص مروية بصوت الغائب إلى أخرى ترويها الشخصية نفسها، (وأحيانا ترويها شخصية أقرب إلى صوت الكاتب نفسه ـ انظر قصة “العلاج المستحيل” ص 100)، فضلا عن أن الراوى قد يتبادل دوره مع بعض الشخصيات التى تتحول هى نفسها إلى رواة (فى قصة “نزف كبرياء مهيض”، مثلا، يتبادل الراوى المتكلم دوره مع “بدرية” زوجه ـ انظر القصة ص 18)، وقد يتمثل الراوى صورة “الحكاء الشعبى” (فى قصة “حدوتة قديمة” يتم اعتماد صوت هذا الحكاء، فتبدأ القصة بالعبارات الشائعة المتعارفة: “يحكى أنه فى سالف العصر والأوان..إلخ” ـ انظر القصة ص 68)، ويتصل بهذا المنحى حضور صيغة خاصة من صيغ “المحكى له”، الذى يدخل أحيانا مع الراوى فى سياق اتصال مباشر: “..دكان (…) حين تجلس فيها تشعر بأنك كما لو كنت تمثل دورا تاريخيا..إلخ” (قصة “بكوية من سوق الكانتو”، ص 82).
ـ 8 ـ
يرتبط بهذا التعدد كله سرد متنوع المستويات، وإن تشبع بتراكيب متجانسة، حية، باتت سمة رئيسية من سمات لغة خيرى شلبى الأثيرة. فمع الانتقالات الواضحة التى نلمحها فى هذا السرد، من قصة لأخرى، وأحيانا من موقف لآخر داخل القصة الواحدة، فيما يخص حيادية السرد أو احتشاده بنوع من عبارات ذات “طابع تعليقى” (“سبحانه وتعالى يربط بين قلوب تتباعد بينها المسافات والأزمنة والأحوال (…) ليلتذاك هو وأخوها يجلسان..إلخ” (قصة “مقام الضوء”، ص 24)، أو فيما يخص احتفاء هذا السرد بعلاقات شعرية بسيطة تتحاور وتتجاور مع تراكيب شائعة أحيانا: (تبرق عيناه الواسعتان فنكاد نرى فيهما شياطين وعفاريت تتقافز وتلعب الكرة بأدمغتنا” (قصة “فتح المندل”، ص 53)، و: “يدق الأرض بعصاه فتتراقص من حولها مسبحته اليسر الطويلة على فتافيت نغم نشوان تصوره حباتها فى اصطدامها بالعصا هبوطا وصعودا” (ص 105).. مع هذا التنوع كله، وغيره من مظاهر انتقالات السرد وتعدده، نلمح عبر قصص المجموعة ما يشى بمستوى أساسى ثابت، ينهض على لغة فصحى تعتمد دمج التراكيب والتعبيرات والأمثال العامية الدارجة الشائعة، بما يبلور نوعا من الحكى يتمثل روح الحياة اليومية، وينتقل بها من نطاق الممارسة إلى حيز الكتابة: “لم يكن ثمة من رقابة ولكن الأدب حينذاك كانوا لا يزالون يفضلونه على العلم..” (ص 34)، “هو عمى لزم” (ص 53)، “يعاملونها برقة وعطف باعتبارها غريبة والغريب مكروم لأجل النبى” (ص 57)، “بدروم بحجم العمارة جاءه على الطبطاب” (ص 70)، “فراح يتصرمح على المقاهى ثم جاء ليختمه على قفاه بهذه البريزة” (ص 72)، “فمنذ أن نفخ المولى فى صورتى ببركة دعاء الوالدين وتوظفت بالثانوية العامة..إلخ” (ص 28)، “حتى اقترب منى ، دحرج المساء، جلس بجوارى” (ص 85)، “فواسانى بابتسامة وبحجر شيشة على حساب المطرح” (ص 87)، “لم يكن بينى وبين القطط أى عمار” (ص 98)، “يغازلهن أحيانا عيانا بيانا” (ص 190)، “يدخل شريكا فى الصفقة، لا بد أن ينوبه من الحب جانب” (ص 138)، “ينزلون على الرغفان حتتك بتتك” (ص 144).
ـ 9 ـ
هذه، إذن، قصص متنوعة رغم ما يصل بينها أو ينتظمها فى دوائر، أو هى قصص مترامية الأبعاد وإن جمع بينها توجّه واحد وانطلقت من اهتمامات واحدة. ولعل هذا يجعل تناولات قصص هذه المجموعة ـ من ناحية ـ تعبيرا عن تجارب متعددة، ويجعلها ـ من ناحية أخرى ـ تمثيلا لبعض قسمات العالم الفنى الخاص بكاتبها وحده.







